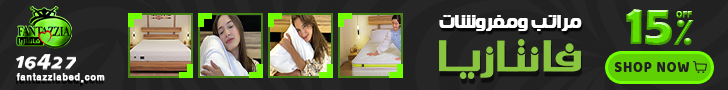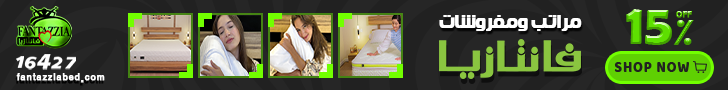رضوى رحيم تكتب: صوت الشيخ محمد رفعت.. شمس لا تغيب
في الليالي الطويلة، حين كانت القاهرة تستعد للنوم، وفي الساعات الأولى من الفجر، حيث يتثاءب النور خجولا على أطراف الأزقة، كان هناك شيء واحد لا ينام، لا يهدأ، ولا يتغير: ذلك الصوت.
كان الصوت يأتي من بعيد، لكنه يسكن القلب فورا ،لا أحد يعرف متى بدأ سماعه لأول مرة، لكنه كان هناك، في كل بيت، في كل حي، في كل روح أرهقها الزمن ثم مسها بطمأنينة خفية.
حين كان محمد رفعت يتلو القرآن أو يرفع الأذان، لم يكن مجرد صوت يسمع، بل كان بابا يفتح بين الأرض والسماء، كان موعدا مقدسا، كان زمنا خاصا.
هل تذكر ذلك الشعور؟ لحظة هدوء مفاجئة تسبق كلماته الأولى، ثم يبدأ الصوت منخفضا، كأنه يناجي الله وحده، ثم يرتفع شيئا فشيئا، فتشعر أن كل شيء حولك يُنصت، أن الهواء صار أثقل، أن قلبك صار أخف، وأن الزمن توقف لبرهة ليسمح للروح بأن تتطهر.
لم يكن صوتا عابرا، بل كان دعوة سرية للقلب كي يعود إلى الله.
الطفل الذي أبصر الله بقلبه
عندما كان محمد رفعت في الثانية من عمره، كانت القاهرة مدينة مختلفة، بيوتها صغيرة، أزقتها ضيقة، وكان الناس لا يزالون يؤمنون أن الصوت الصادق يمكنه أن يغير حياة بأكملها.
ثم جاء المرض، وأُغلقت عينا الصغير إلى الأبد.
تخيل طفلا لا يرى الشمس، لا يرى الوجوه، لا يرى الطريق، لكنه يجد في صوته ما لم يجده الآخرون في أبصارهم.
حين بدأ في حفظ القرآن، لم يكن يحفظه فقط، بل كان يسمعه كما لم يسمعه أحد من قبل. كل حرف كان نبضة، كل آية كانت ضوءا، كل سورة كانت سفرا بعيدا لا يقدر عليه إلا من أبصر بقلبه ما لم تبصره العيون.
وحين كبر، لم يكن صوته مجرد وسيلة للتلاوة، بل كان نافذة تفتح على الجنة، وطريقا يسير عليه المستمع فيجد نفسه أقرب إلى الله دون أن يدري كيف وصل.
كيف يصبح الصوت وطنا؟
لم يكن محمد رفعت مجرد شيخ يقرأ القرآن، ولا كان مؤذنا يعلن مواقيت الصلاة، بل كان روحا تقيم في وجدان الناس، في بيوتهم، في لحظاتهم المقدسة.
في البيت المصري، حيث الأم تعد طعام الإفطار، والأب يفتح المذياع العتيق، والأطفال ينتظرون موعد الأذان بلهفة، كان صوته الجسر الذي يعبر بهم إلى لحظة يلتقون فيها بالله بعد يوم طويل من الصيام.
كانت البيوت تتهيأ لموعد أذانه كما تتهيأ لاستقبال ضيف عزيز، وكانت القلوب تهدأ، والأرواح تخشع، وكأن الزمن يعود إلى الوراء، إلى الأيام التي كان فيها الإيمان أكثر نقاء، وأكثر بساطة.
كان صوت محمد رفعت وطنا، والوطن لا ينسى.
حين سكت الصوت، ولم يسكت الأثر
في أواخر حياته، أصيب محمد رفعت بمرض في حنجرته، المرض الذي جاء كاختبار أخير لرجل منح العالم صوته، ثم وجد نفسه فجأة بلا صوت.
كان الألم شديدا، لكن ما كان أشد منه هو ذلك الصمت الذي حل فجأة بعد سنوات من التلاوة والابتهال.
لكن الشيخ لم يجزع، لم يغضب، لم يرفع صوته بالشكوى، فقط ابتسم وقال:
"إن الله أعطاني هذا الصوت، وهو الذي أخذه."
ثم جاء اليوم الأخير، 9 مايو 1950، حين رحل عن الدنيا، لكن صوته لم يرحل.
لا يزال هناك، في المآذن، في القلوب، في الأشرطة القديمة، في الراديوهات التي لا تزال تحتفظ به كأنه كنز لا يُمس.
لماذا لا ننساه؟
لأن بعض الأصوات أكثر من مجرد أصوات، لأنها تصبح جزءًا من ذاكرتنا الروحية، من طفولتنا، من يقيننا بأن هناك شيئًا في هذا العالم لا يتغير، لا يغيب، لا يختفي مع الزمن.
لأن محمد رفعت لم يكن مجرد قارئ، بل كان أول من سُجّل صوته في الإذاعة المصرية، فصار صوته أول ما تسلل إلى البيوت عبر الأثير، وأول ما ارتبط في الوجدان بتلاوة القرآن والأذان.
لأن صوته لم يكن فقط جميلًا، بل كان يحمل رهبة عظيمة، وصدقا نادرا، وحزنا خفيا كأنه يهمس لكل قلب متعب: عد إلى الله، ستجد السلام.
لأن البيوت كانت تنتظر أذانه كما تنتظر رمضان ذاته، وكان غيابه عن الأثير يجعل الناس يشعرون أن هناك خطأ ما، كأن الزمن لم يتحرك كما ينبغي، وكأن لحظة الغروب لم تكتمل بعد.
لأنه كان رجلا لم يبحث عن المال ولا الشهرة، بل عن رضا الله. رفض أن يباع صوته لشركات أجنبية رغم الإغراءات، لأنه لم يشأ أن تكون كلمات الله تجارة، ولم يكن يرى في صوته إلا أمانة وهبها الله له، وحين أخذها منه، لم يسخط، لم يغضب، بل اكتفى بأن يبتسم"
وفي كل رمضان، حين يرفع صوته في الأثير، نشعر أنه لم يغب أبدا، نشعر أن الآذان لا يزال ينبض بالحياة، وأن هناك أصواتا لا تموت، لأن الله اختار لها أن تكون جزءا من وجدان الناس، جزءا من لحظاتهم المقدسة، جزءا من صلاة لا تنتهي.
ولأننا في كل رمضان، نفتح الراديو عند المغرب، ونسمع صوته يقول: "الله أكبر.. الله أكبر..".
الأكثر قراءة
أكثر الكلمات انتشاراً