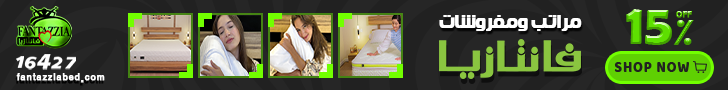وسام شرف | خارج حدود الأدب
في أربعينيات القرن التاسع عشر، وتحديدًا في جناح التوليد بمستشفى فيينا العام، لاحظ الطبيب المجري (إجناز فيليب سيميلويس) أن معدل الوفيات بين النساء حديثي الولادة بسبب حمى النفاس كان مرتفعًا للغاية في هذا القسم، حتى بالمقارنة بمعدل الوفيات في جناح القابلات. في ذلك الحين، لم يكن (لويس باستور) و(جوزيف ليستر) قد اكتشفا بعد دور الكائنات الدقيقة في انتشار العدوى وطرق الحد منها، وكان السائد أن "الأبخرة الضارة" وحدها هي المسؤولة عن ذلك.
وفي العام 1847، تعرض المستشفى لحادث مؤلم، إذ توفي أحد الأطباء بسبب تعفن الدم إثر إصابته بالعدوى بعد أن جرح نفسه بمشرط أثناء تشريح جثة مصابة بحمى النفاس. أثارت هذه الحادثة فضول (سيميلويس) للبحث في أسباب انتشار العدوى في جناح الأطباء، والعمل على الحد منها. وبعد بحث، لاحظ أن الأطباء وطلاب الطب ينتقلون من تشريح الجثث إلى فحص النساء الحوامل مباشرةً، دون غسل أيديهم.
عندها أدرك (سيميلويس) أن حمى النفاس قد تكون ناجمة عن "مواد عفنة" يتم نقلها من الجثث إلى الأمهات عن طريق الأيدي غير النظيفة. توصل إلى أن غسل الأيدي بمحلول يحتوي على الكلور يمكن أن يقضي على هذه المواد العفنة. وبدأ بعرض نظريته على زملائه في القسم، وفرض غسل الأيدي بمحلول الكلور على جميع الأطباء وطلاب الطب قبل فحص الأمهات. وعندها، انخفضت نسبة الوفيات بشكل كبير من حوالي 18% إلى أقل من 2%. وكانت هذه النتائج مذهلة.
لكن هذه النتائج أحدثت هزة كبيرة في المجتمع، وخاصة بين الأطباء، إذ قوبلت أفكار (سيميلويس) بالسخرية والاستهزاء. لم يكن المجتمع الطبي مستعدًا لتقبل فكرة أن الأطباء أنفسهم قد يكونون سببًا في نشر العدوى. بل اعتُبرت أفكاره مهينة للأطباء، الذين رفضوا فكرة أنهم بحاجة إلى تنظيف أيديهم، معتبرين هذا أمرًا غير ضروري ويدعو إلى التشكيك في مهاراتهم.
وبعد محاولات مضنية من (سيميلويس) لإقناع المجتمع الطبي بنظريته، قوبلت مساعيه بالاضطهاد والرفض، ومن ثم طُرد من مستشفى فيينا العام، مما أثر على حالته النفسية. وفي عام 1865، تدهورت صحته النفسية إلى حد كبير، مما أدى إلى نقله إلى مصحة نفسية، حيث تعرض للعنف من الحراس وتوفي بعد إصابته بعدوى تشبه حمى النفاس، في مفارقة مؤلمة.
ولم يُعترف بفضل (سيميلويس) إلا بعد وفاته بسنوات، عندما جاء علماء مثل (لويس باستور) و(جوزيف ليستر) وأثبتوا صحة النظرية الجرثومية، التي تشير إلى أن الجراثيم هي المسؤولة عن العدوى. ثم اعتُبر (سيميلويس) أحد رواد النظافة الطبية، وتم الاحتفاء بإسهاماته التي ساعدت في إنقاذ حياة الملايين من خلال فهم أهمية النظافة.
بالطبع، لم تكن تلك حادثة فردية منفردة في التاريخ، فالعقل الجمعي للمجتمع دائمًا ما يقابل الآراء والنظريات المختلفة بالرفض، وغالبًا ما يكون هذا الرفض حادًا. فالمجتمع يرفض تعريته أمام نفسه، فضلًا عن الاعتراف بقصوره أو أخطائه. تمامًا كما رفض الأطباء الاعتراف بنظرية (سيميلويس) واعتبروها إهانةً وتشكيكًا في نظافتهم ومهاراتهم، أرى المجتمع الآن منقسمًا حول الطبيبة (وسام) التي قررت الإشارة إلى ظاهرة خطيرة.
وبدلًا من مواجهة تلك الظاهرة ومعالجة أسبابها والحد من انتشارها، ضرب المجتمع بسياطه الطويلة تلك الطبيبة يجلدونها، وكأنهم جميعًا كالنعام، يدفنون رؤوسهم في الرمال، محاولة لوأد العار الذي أشارت إليه، بينما كانوا أسودًا في نقدها والتنكيل بها. وتقدم مشهد منتقديها أعتى عتاولة الإعلام، مشككًا في مهنيتها ومتناسيا مهنية وظيفته.
وإن كانت الطبيبة (وسام) قد أخطأت في الأسلوب أو طريقة العرض أو حتى في اختيار الألفاظ، لكنها آبدًا لم تفضح اسم مريض بعينه أو حالة بذاتها، بل سلطت الضوء على إحدى النقاط السلبية التي يعاني منها المجتمع؛ ظاهرة نرى أربابها وأدعياءها يطلون علينا كل يوم من أبواب مختلفة. لدرجة أن الإعلام نفسه -الذي يسن السيوف لذبح (وسام)- استضاف من قبل ويستضيف كل يوم عبر منابره رؤوس الفتنة تلك، غير عابئ بقيم المجتمع، ولا يسعى إلا وراء الترند.
حاسبوا (وسام)، ولكن بعد أن تقيّموا ما أثارته. حاسبوها بعد أن تغلقوا منابر العري والشيطان على إنستجرام وفيس بوك وتيك توك. حاسبوها بعد أن نعيد للمجتمع قيمه وأخلاقه بالتعليم والفن النظيف والمنابر الناصحة. ولكن لا تقتلوها كمدًا كما قُتل (سيميلويس)، لأنها قررت أن تعبر عن رأيها أو فضحت ظاهرة خطيرة. حاسبوها قبل أن يخرج المجتمع كله خارج حدود الأدب.
الأكثر قراءة
-
تدافع وتحرش، خناقات بالكراسي فى زفاف كروان مشاكل وحفيدة شعبان عبدالرحيم
-
بعد مشاجرة فرحه، القبض على التيك توكر كروان مشاكل
-
بعد إعلان اغتياله رسميًا، "حماس" تكشف عن صورة واسم أبو عبيدة الحقيقي
-
بعد إعلان "القسّام" اغتياله رسميا، من هو أبو عبيدة؟
-
"الأموات هينتخبوا"، قرار مٌخالف يهدد ببطلان انتخابات حزب الوفد
-
فيديو لـ إنجي حمادة يكشف بداية مشاجرة فرح كروان مشاكل
-
"اتجوزت 4 مرات ومعايا إعدادية".. نص التحقيقات مع البلوجر نورهان حفظي (خاص)
-
تشبث به لآخر لحظة، بطل صغير يحاول إنقاذ ابن شقيقته من الاختطاف بكفر الشيخ
مقالات ذات صلة
مرايا الدخان؛ التي تزيغ الأبصار والبصائر! | خارج حدود الأدب
29 ديسمبر 2025 01:41 م
فوز مصري صعب؛ على نغمات الموتور الخربان| خارج حدود الأدب
26 ديسمبر 2025 10:51 م
الست ما بين قبول «الخلاعة» ورفض «اغضب» | خارج حدود الأدب
21 ديسمبر 2025 05:21 م
سياحة القنص: العار الأوروبي الذي فضحته مباراة كرة قدم! | خارج حدود الأدب
17 نوفمبر 2025 03:29 م
مدد يا ممداني مدد! | خارج حدود الأدب
05 نوفمبر 2025 06:23 م
طه الدسوقي؛ وإهانة الذات الصحفية! | خارج حدود الأدب
19 أكتوبر 2025 04:33 م
ChatGPT يتسبب في حبس طفل بأمريكا.. خارج حدود الأدب
07 أكتوبر 2025 10:36 م
ميدو وصديقه زلاتان | خارج حدود الأدب
03 أكتوبر 2025 02:17 م
أكثر الكلمات انتشاراً